المرور في المسجد واتخاذه طريقاً لغير حاجة.

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه والتابعين, أما بعد: فإنَّ المساجد لها مكانتها وشرفها، فلا يجوز امتهانها بكثرة المرور والعبور فيها دون حاجة ضرورية، وإنما لمجرد العادة أو اختصار الطريق، فأما إن كان المرور لحاجة فلا بأس بذلك، وهو ما كان يقع في المسجد النبوي.
وقد ترجم البخاري في صحيحه (باب المرورِ في المسجد) وذكر فيه حديث أبي موسى رفعه: (مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا)1.
قال النووي -رحمه الله- عن هذا الحديث: "فيه هذا الأدب، وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما, والنصول والنصال جمع نصل، وهو حديدة السهم, وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر2.
وفي صحيح البخاري -أيضاً-: «مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَمْسِكْ بنصَالِهَا")3. ولعلّ ذلك كان لحاجة ألجأته إلى المرور، وقد يراد بالمرور الدخول لصلاة أو عبادة ونحو ذلك.
وهكذا روي في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} (43) سورة النساء. عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: "لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل, قال: تمر به مرًا ولا تجلس"4.
وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالاً كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد، فأنزل الله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ}5, وفي هذا جواز مرور الجنب في المسجد لحاجة الإتيان بالماء أو للاغتسال، ولا يجوز لغير حاجة، فقد روى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»6.
لكن قال الخطابي: إن أفلت مجهول، وضعف الحديث به، وتعقبه المنذري في تهذيب السنن، وابن القيم في شرح التهذيب بأنه معروف، وقد وثقه بعض الأئمة7, وقد روى البخاري هذا الحديث في ترجمة أفلت من تاريخه الكبير، ولم يجرح أفلت، وسماه بعضهم: فليت، ولكنه ذكر أن عند جسرة عجائب8، وقد رواه ابن ماجه عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، عن أم سلمة بلفظ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ»9. قال في الزوائد: "إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول", ويمكن أنه عن جسرة عن عائشة وأم سلمة إن كان ثابتاً، ولعل نهي الحائض مخافة تلويث المسجد، ومتى أمن ذلك جاز دخولها المسجد.
والحديث قد حسنه الزيلعي في نصب الراية عن عائشة، وناقش ما قيل في إسناده من المقال10.
وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ" قَالَتْ: فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ, فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)11. ثم روى نحوه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- ولفظه: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ, نَاوِلِينِي الثَّوْبَ, فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ, فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ, فَنَاوَلَتْهُ»12. وظاهره أنه طلب منها ثوباً وهو في المسجد فأتت به، ولم يمنعها الحيض، ولعلها أمنت من التلويث، أو اعتبرت أن النهي عن الجلوس فيه.
وأما الجنب فلعل النهي عن دخوله المسجد لأنه محدث حدثًا أكبر، والمسجد موضع للعبادة، فلابد أن يكون محل احترام، فلا يجلس فيه الجنب، وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى منع الجنب من المسجد حتى يغتسل، لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} أي: لا تقربوا أماكن الصلاة، قال ابن كثير –رحمه الله- عند تفسير الآية: "ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضًا في معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث, ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فل13.
وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز دخول الجنب المسجد إذا توضأ، وروي عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون في المسجد للتعلم وهم جنب إذا توضؤا، ذكر ذلك ابن كثير –أيضاً- عند تفسير هذه الآية, وروى ذلك بإسناد سعيد بن منصور، عن عطاء بن يسار، قال: "رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة, وقال: "إسناده صحيح على شرط مسلم"14.
والله أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمئاب, وصلى الله وسلم على نبيه الكريم, وسبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, والحمد لله رب العالمين15.
1 رواه البخاري -433- (2/ 243).
2 شرح النووي على مسلم - (8/447).
3 رواه البخاري -432- (2/241).
4 تفسير ابن أبي حاتم - (19/20).
5 تفسير ابن كثير - ( 2/311).
6 رواه أبو داود -201- (1/294).
7 انظر كلام الخطابي والمنذري وابن القيم على الحديث في تهذيب السنن برقم 220.
8 ترجم البخاري لأفلت برقم 1710.
9 رواه ابن ماجه -637-(2/312).
10 انظر: كتاب فصول ومسائل تتعلق بالمساجد (1/55) للشيخ:عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.نقلاً عن نصيب الراية(1/ 193) وقد أطال صاحب الراية في تقوية الحديث.
11 رواه مسلم -450- (2/162). والخمرة: هي السجادة من حصير أو نسيجة من خوص انظر:شرح النووي على مسلم - (1/481).
12 رواه مسلم -452- (2/164).
13 تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 311).
14 تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 313).
15 من كتاب: فصول ومسائل تتعلق بالمساجد (1/55-57) للشيخ:عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. (بتصرف).
الحمد لله الذي جعل المساجد للمسلمين, بمثابة الأندية والمعسكرات والميادين, وجعل الجمع والجماعات من أعظم شعائر الدين. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير, وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلَّم تسليماً كثيراً ... أما بعد:
لقد اقتضت حكمة الله -تبارك وتعالى- أن ينتقل الناس من مكان لآخر، لأسباب اختيارية، كالبحث عن الرزق، أو قهرية كالحرائق والآفات السماوية التي تهلك الناس -بقدر الله تعالى-. فإن انتقل الناس بسبب الفيضانات، وصارت المساجد في لجة المياه، فإن آلاتها ووظائفها والقائمين عليها وحجارتها ونقضها تنقل إلى مساجد أخرى1, وأما إذا لم تخرب المساجد، ولم يخرب ما حولها، فلا يحل بيعها، وإن بيعت، فلا يتملكها مشتريها، ولا يملك قيمتها بائعها وأما إن خرب المسجد أو خرب ما حوله وهجره الناس وتعطلت منافعه, فقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى-
على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه،كانهدام جزء من المسجد، أو خراب آلاته وأبوابه ونوافذه، وتساقط سقفه، أو ضاق المسجد بأهله -عند أحمد- أو خربت المساكن التي حوله ولم يكن حوله من يسكنها، وليس المسجد في طريق، ولا يصلي فيه أحد2 ويكون ذلك بإذن القاضي، وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد, ويستحسن عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف: أن يكون الثمن مصروفاً إلى مسجد قريب من المسجد الذي بيع, وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف3, وهو رواية عن الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الحنابلة كما ذكره في الإنصاف4.
ودليل أصحاب هذا القول ما يلي:
أ- كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة:
"انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل". وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر ما يخالفه، فكان إجماع5.
ب- ولأن الوقف إذا انتقل من مالكه، فإنه لا يعود إليه إن تعطك منافعه، ولا إلى ورثته، فبقاؤه وقد تعذر الانتفاع به لا فائدة منه، فقد فات الغرض المقصود من الوقف، وهو التصدق بثمرته والانتفاع به6. ولتحقيق الغرض من الوقف قد جاز بيعه واستغلال قيمته في وقف آخر7.
ج- أجمع العلماء على جواز بيع الفرس إذا كبرت وتعطلت منافعها، حين تكون وقفاً للغزو والانتفاع بقيمتها، فالمسجد مثلها إذا تعطلت منافعه8.
القول الثاني:
لا يصح بيع الوقف بحال، والمسجد لا يكون إلا وقفاً، فلا يصح بيعه وإن تعطلت منافعه,. وهذا رواية عن أبي حنيفة، وهي المذهب عند الأحناف, وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد9.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أ- عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب, وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول»10.
والشاهد: قوله:"حبست أصلها وتصدقت بها... لا يباع ولا يوهب ولا يورث ..الخ .".
وجه الدلالة: أن بيع الوقف مناف لبقائه وتحبيس أصله، وقد اشترطه عمر في مجمع من الصحابة، وأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- فدل ذلك على أن بيع الوقف لا يجوز بكل حال؛ إذ لو جاز لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ب- ولأن المسجد موقوف كالرجل المعتق لخدمة المسجد إن تعطلت منافعه فلا يصح بيعه11.
القول الثالث:
قال محمد بن الحسن: إن الوقف إذا تعطلت منافعه يرجع إلى الورثة12, ومفاد قوله هذا أنه يجوز بيع المسجد؛ لأن الورثة سيتصرفون به إذا رجع إليهم، وقد يبيعونه ويأخذون ثمنه.
واستدل لمحمد بن الحسن: بأنه -أي الواقف- جعل هذا الجزء من ملكه، مصروفاً إلى قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه كالمحصر إذا بعث الهدي، ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء13.
المناقشة:
اعترض أصحاب القول الثاني على القائلين بجواز بيع المسجد بأن فعل عمر -رضي الله عنه- لا يعارض بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- الثابت، كيف وقد امتثل عمر هذا القول؟.
وأجيب عن هذا: بأنه لا تعارض -كما ذكرتم- وإنما فهم عمر والصحابة أن الوقف لا يباع إذا لم تتعطل منافعه, أما إذا تعطلت منافعه فقد فات غرض الواقف. وبهذا ظهر وجه الجمع بين حديث عمر، وبين أمره بنقل المسجد.
ويرى أصحاب القول الثاني: أن فعل عمر يسقط الاحتجاج به؛ لأنه عارض دليلاً أقوى منه.
والقاعدة الشرعية أنه ما دام يمكن الجمع بين القولين فلا وجه للقول بالتعارض14.
وأما الرجل المعتق لخدمة المسجد، فإن أعتقه مولاه تحريراً لرقبته من أن يستعبده مخلوق، أو ينتفع به بخدمة خاصة ونحوها بلا أجرة أو إحسان منه، فإن خدمة المسجد إما أن تكون شرطاً لعتقه، فيعتق بما يسمى عرفاً خدمة المسجد، وحين يعتق يكون قد ملك أمره، وإما أن تكون هذه الخدمة بذاتها وقفاً، فيقول: جعلت فتاي فلاناً وقفاً لخدمة المسجد الفلاني، فيجري مجرى الوقف، يباع إن تعطلت منافعه في خدمة المسجد، لكن الغالب أنه لا يشتريه إلا من سيعتقه، أو ينتفع منه بمصلحة أخرى, أما الذي وقفه أولاً على خدمة المسجد فلم يعتقه15. ولأن الجمود على العين الموقوفة مع تعطل منافعها وفوات المصلحة منها يؤدي إلى خراب المسجد الآخر الذي يحتاج لإصلاح فنكون قد أفسدنا مسجدين, ولأن اللصوص وغيرهم ربما أخذوا آلات المسجد الخرب وما فيه ، فتذهب هباء بلا منفعة16.
وأما دليل محمد بن الحسن فيجاب عنه: بأنه إزالة ملك على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلا يعود لمالكه كالعتق. وحيث إن الوقف يتأبد، فإنه إذا تعذر بقاء صورة الوقف يجوز الانتقال إلى إبقاء معناه, وذلك بنقل قيمته وآلته وبنائه لمسجد آخر يقوم مقامه؛ لئلا يفوت الانتفاع بالوقف كله، فينتفع بما بقي منه وهو آلته أو قيمته أو نحوه17.
وإذا بيع المسجد واشتُري بقيمته أرض أو بيت، وجعلت مسجداً، فإن البدل يقوم مقام المبدل عنه في تنفيذ شروط الواقف الأصلي، فتكون وظائف المسجد الخرب هي وظائف المسجد الجديد، فالإمام هو الإمام، وهكذا المؤذن وغيره، وتكون فرش المسجد الأول وآلته وغلة ما وقف له للمسجد الجديد18؛ لأن أدوات المسجد لها حكم المسجد فيما تقدم19. وإن كانت هذه الأدوات زائدة عن حاجة المسجد الجديد، فتعطى لمسجد آخر، فإن زادت عن حاجته فلثالث وهكذا.
ويتولى بيع المسجد الإمام أو نائبه، أو الناظر بعد أن يأذن له الحاكم الشرعي20.
والله أعلم, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم,
والحمد لله رب العالمين.
1 انظر : حاشية قليوبي وعميرة ( 2 / 3 / 109 ).
2 انظر : الإنصاف ( 7 / 103 ) ، والفروع ( 4 / 626 ) .
3 المبسوط للسرخسي ( 12 / 42 ـ 43 ) ، وحاشية ابن عابدين ( 4 / 358 ـ 359 ) .
4 الإنصاف للمرداوي ( 7 / 101 ) ، والروض المربع بحاشية ابن قاسم ( 5 / 564 ) ، والمغني لابن قدامة ( 5 / 631 ).
5 انظر: المغني - (ج 12 / ص 236). وشرح فتح القدير لابن الهمام ( 5 / 445 ).
6 انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 358)، والمبسوط (6 / 12 / 32 ـ 43).
7 انظر: كتاب أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - (ج 1 / ص 94) نقلاً عن المغني ( 5 / 633 ).
8 انظر: المرجع السابق، والفروع ( 4 / 633 ).
9 انظر: المبسوط للسرخسي ( 6 / 12 / 42 ) ، وشرح فتح القدير لابن الهمام ( 5 / 445 ) . جواهر الإكليل ( 2 / 209 ) . المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي ( 14 / 264 الفروع لابن مفلح ( 4 / 622 ) نقلاً عن:أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - (ج 1 / ص 93).
10 رواه البخاري -2532- (ج 9 / ص 263). صحيح مسلم -3085- (ج 8 / ص 407).
11 أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - (ج 1 / ص 95) نقلاً عن: المغني لابن قدامة ( 5 / 632 )
12 المبسوط للسرخسي ( 6 / 12 / 42 ) .
13 المرجع السابق.
14 أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية(1/95) لـ(إبراهيم بن صالح الخضيري).
15 المرجع السابق (1/96) نقلاً عن: أحكام القرآن للجصاص ( 1 / 61 )، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 32 ).
16 المرجع السابق نقلاً عن: حاشية ابن عابدين (4/ 359)، وشرح المهذب تكملة المطيعي(14/264).
17 المرجع السابق (1/97) نقلاً عن: شرح فتح القدير لابن الهمام (5/446)، وحاشية ابن عابدين(4/359-360), والمغني (5/633).
18قواعد الفقه لابن رجب الحنبلي ( ص315 ) .
19 المغني لابن قدامة ( 5 / 635 ) .
20 الفروع لابن مفلح ( 4 / 626 ) ، والإنصاف ( 7 / 105 ) .
موقع إمام المسجد

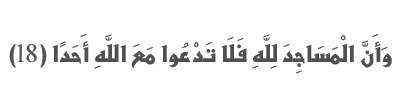

 تسمية المسجد
تسمية المسجد 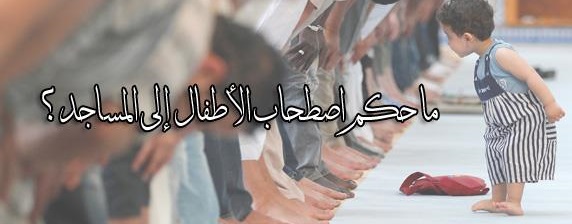 المساجد والأطفال
المساجد والأطفال 




.jpg)
.jpg)

التعليقات